
وأما حديثُ نافِع بن عجير الذى رواه أبو داود، أن ركانة طلق امرأته ألبتة، فأحلفه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أرادَ إلا واحدة، فمن العجب تقديمُ نافع ابن عجير المجهول الذي لا يُعرف حاله ألبتة، ولا يُدرى من هو، ولا ما هو على ابن جريج، ومعمر، وعبد الله بن طاووس فى قصة أبى الصهباء، وقد شهد إمامُ أهل الحديث محمدُ بن إسماعيل البخارى بأن فيه اضطراباً، هكذا قال الترمذى فى الجامع، وذكر عنه فى موضع آخر: أنه مضطرب. فتارةً يقول: طلقها ثلاثاً، وتارةً يقول: واحدةً، وتارة يقول: البتة، وقال الإمام أحمد: وطرقه كُلُّها ضعيفة، وضعفه أيضاً البخارى، حكاه المنذرى عنه. ثم كيف يُقدَّم هذا الحديثُ المضطربُ المجهولُ رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لِجهالة بعض بنى أبى رافع، هذا وأولادُه تابعيون، وإن كان عبيد الله أشهرَهم، وليس فيهم متهم بالكذب، وقد روى عنه ابنُ جُريج، ومَنْ يقبلُ روايةَ المجهول، أو يقولُ: روايةُ العدل عنه تعديلٌ له، فهذا حجةٌ عنده، فأمَّا أن يُضعِّفَه ويُقَدِّمَ عليه روايةَ من هو مثلُه فى الجهالة، أو أشدُّ، فكلاَّ، فغايةُ الأمر أن تتساقَط روايتا هذين المجهولين، يُعْدَل إلى غيرهما، وإذا فعلنا ذلك، نظرنا فى حديث سعد بن إبراهيم، فوجدناه صحيح الإسناد، وقد زالت علةُ تدليسِ محمد ابن إسحاق بقوله: حدثنى داود بن الحصين، وقد احتج أحمد بإسناده فى مواضع، وقد صحح هو وغيرُه بهذا الإسناد بعينه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ زينبَ على زوجِها أبى العاص بن الربيع بالنِّكاحِ الأوَّلِ، ولم يُحدث شيئاً. وأما داودُ بن الحُصين، عن عكرمة، فلم تزل الأئمة تحتجُّ به، وقد احتجُّوا به فى حديث العَرَايا فيما شُكَّ فيه، ولم يُجْزَمْ به مِن تقديرها بخمسة أوسُق أو دونَها مع كونِها على خلاف الأحاديث التى نهى فيها عن بيع الرُّطَبِ بالتمرِ، فما ذنبه فى هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به، وإن قدحتُم فى عكرمة ولعلكم فاعِلون جاءكم ما لا قِبَلَ لكُم به من التناقض فيما احتججتُم به أنتُم وأئمةُ الحديث مِن روايته، وارتضاء البخارى لإدخال حديثه فى ((صحيحه)).
فصل
وأما تلك المسالك الوَعْرَةُ التى سلكتموها فى حديثِ أبى الصهباء، فلا يَصِحُّ شىء منها.
أما المسلكُ الأول، وهو انفرادُ مسلم بروايته، وإعراضُ البخارى عنه، فَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْهُ عَارُهَا، وما ضرَّ ذلك الحديثَ انفرادُ مسلم به شيئاً، ثم هل تقبلون أنتم، أو أحدٌ مثل هذا فى كُلِّ حديثٍ يَنْفَرِدُ به مسلم عن البخارى، وهل قال البخارىُّ قطُّ: إن كُلِّ حديث لم أُدْخِلْه فى كتابى، فهو باطل، أو ليس بحجة، أو ضعيف، وكم قد احتج البخارىُّ بأحاديث خارجَ الصحيح ليس لها ذكر فى ((صحيحه))، وكم صحَّح مِن حديث خارجٍ عن صحيحه. فأما مخالفةُ سائرِ الروايات له عن ابن عباس، فلا ريبَ أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك. إحداهُهما: تُوافق هذا الحديثَ، والأُخرى: تُخالفه، فإن أسقطنا رواية برواية، سَلِمَ الحديثُ على أنه بحمد الله سالم. ولو اتفقتِ الرواياتُ عنه على مخالفته، فله أسوةُ أمثاله، وليس بأوَّلِ حديث خالفه روايه، فنسألكم: هل الأخذُ بما رواه الصحابى عندكم، أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخذُ بروايته، وهو قولُ جمهوركم، بل جمهورُ الأمة على هذا، كفيتُمونا مؤونة الجوابِ. إن قلتُم: الأخذُ برأيه، أَريناكُم مِن تناقضكم ما لا حِيلة لكم فى دفعه، ولا سيما عن ابن عباس نفسِه، فإنه روى حديث بَريرة وتخييرها، ولم يكن بيعُها طلاقاً، ورأى خلافَه، وأن بيعَ بالأمة طلاقُها، فأخذتُم وأصبتُم بِروايته، وتركتم رأيه، فهلا فعلتُم ذلك فيما نحن فيه، وقلتم: الرواية معصومة، وقولُ الصحابى غيرُ معصوم، ومخالفته لما رواه يحتمِلُ احتمالاتٍ عديدة من نسيان أو تأويل، أو اعتقاد مُعارِض راجحٍ فى ظنه، أو اعتقادِ أنه منسوخ أو مخصوص، أو غير ذلك من الاحتمالات، فكيف يسوغُ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا تركُ معلوم لِمظنون، بل مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه حديثَ التسبيعِ من ولُوغ الكلب، وأفتى بخلافه، فأخذتُم بروايته، وتركتُم فتواه. ولو تتبعنا ما أخذتُم فيه بروايةِ الصحابى دونَ فتواه، لطال.
قالُوا: وأما دعواكم نسخ الحديث، فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم متراخ، فأين هذا؟
وأما حديثُ عكرمة، عن ابن عباس فى نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث، فلو صحَّ، لم يكن فيه حجة، فإنه إنما فيه أن الرَّجل كان يُطَلِّقُ امرأته ويُراجعها بغير عدد، فنُسِخَ ذلك، وقُصِرَ على ثلاث، فيها تنقطع الرجعة، فأين فى ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد، ثم كيف يستمرُّ المنسوخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، وصدراً من خلافة عمر، لا تعلم به الأمة، وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج، ثم كيف يقول عمر: إن الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة، وهل للأمة أناة فى المنسوخ بوجه ما؟، ثم كيف يُعارض الحديثُ الصحيحُ بهذا الذى فيه على بن الحسين ابن واقد، وضعفُه معلوم؟
وأما حملُكم الحديثَ على قول المطلِّق: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ومقصودُه التأكيد بما بعد الأول، فسياقُ الحديث مِن أوله إلى آخره يردُّه، فإنَّ هذا الذى أوَّلتم الحديثَ عليه لا يتغيرُ بوفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختِلفُ على عهده وعهدِ خُلفائه، وهَلُمَّ جراً إلى آخر الدهر، ومن ينويه فى قصد التأكيد لا يُفَرِّقُ بين بَرٍّ وفاجر، وصادق وكاذب، بل يردُّه إلى نيته، وكذلك مَن لا يقبله فى الحكم لا يقبلُه مطلقاً بَراً كان أو فاجراً.
وأيضاً فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتابعوا فى شىء كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم. إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله فى فُسحة منه، وشَرَعَهُ متراخياً بعضه عن بعض رحمةً بهم، ورفقاً وأناة لهم، لئلا يندم مطلِّق، فيذهب حبيبُه مِن يديه مِن أول وهلة، فَيَعِزُّ عليه تدارُكه، فجعل له أناةً ومُهلةً يستعتِبُه فيها، ويرضيه ويَزولُ ما أحدثه العتبُ الداعى إلى الفراقُ، ويُراجع كُلٌّ منهما الذى عليه بالمعروف، فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومُهلة، وأوقعوه بفم واحد، فرأى عمر رضى الله عنه أنه يلزمُهم ما التزموه عقوبةً لهم، فإذا عَلِمَ المطلِّق أن زوجته وسكنه تحرُم عليه من أول مرة بجمعه الثلاثَ، كفَّ عنها، ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه، وكان هذا مِن تأديب عمر لرعيته لما أكثرُوا مِن الطلاق الثلاث، كما سيأتى مزيدُ تقريره عند الاعتذار عن عمر رضى الله عنه فى إلزامه بالثلاث، هذا وجهُ الحديث الذى لا وجه له غيرُه، فأين هذا من تأويلكم المستكرَهِ المستبعَدِ الذى لا تُوافقه ألفاظُ الحديث، بل تنبُو عنه، وتُنافره.
وأما قولُ مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الآن على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدةً، فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُونَ واحدة، وعلى عهد عمر صاروا يطلِّقون ثلاثاً، والتأويلُ إذا وصل إلى هذا الحد، كان مِن باب الالغاز والتحريف، لا من باب بيان المراد، ولا يَصِحُّ ذلك بوجه ما، فإن الناسَ ما زالوا يُطلِّقون واحدة وثلاثاً، وقد طلَّق رجالٌ نساءهم على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فمنهم من ردَّها إلى واحدة، كما فى حديث عكرمة عن ابن عباس. ومنهم من أنكر عليه، وغَضِبَ، وجعله متلاعباً بكتاب الله، ولم يُعْرَفْ ما حكم به عليهم، وفيهم من أقَّره لتأكيد التحريم الذى أوجبه اللعان، ومنهم من ألزمه بالثلاث، لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث، فلا يَصِحُّ أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر، فطلقوا ثلاثاً، ولا يَصِحُّ أن يقال: إنهم قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة، فنمضيه عليهم، ولا يُلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عهده بوجه ما، فإنه ماضِ منكم على عهده وبعدَ عهده.
ثم إن فى بعض ألفاظِ الحديث الصحيحة: ألم تعلم أنه من طلَّق ثلاثاً جُعِلَتْ وَاحِدَة على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وفى لفظ: أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وصدراً من خلافة عمر، فقال ابن عباس: بلى كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثاً قبل أن يدخُلَ بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس يعنى عمر قد تتايعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم، هذا لفظُ الحديث، وهو بأصح إسناد، وهو لا يحتمِلُ ما ذكرتُم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا كله عَمَلُ من جعل الأدلة تبعاً للمذهب، فاعتقد، ثم استدل. وأما من جعل المذهب تبعاً للدليل، واستدل، ثم اعتقد، لم يمكنه هذا العمل.
|
 الإهداءات
الإهداءات الإهداءات
الإهداءات
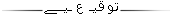

 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه